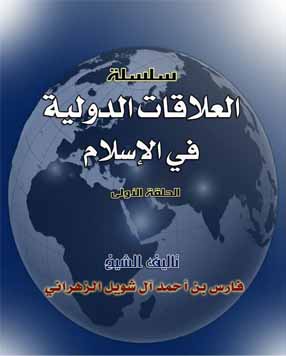في حين تختلف التوجهات السلفية (العلمية، الدعوية، الجهادية، الإصلاحية) في تغليبها للأولويات، فإنها تتفق في حرصها على توسيع نطاق الثابت والتضييق على المتحول.
بقلم: حسن منيمنة

والواقع إنها قد نجحت بقدر ملحوظ خلال العقود الماضية في إرساء قناعة أن المعيارية الإسلامية تقتضي هذا الحرص، وذلك في أوساط السلفيين أنفسهم وسائر الإسلاميين، كما في أوساط المسلمين عامة من ملتزمين ومحافظين، بل حتى العديد من المنفتحين. فتبرز لدى هؤلاء مثلاً إشكاليات التوفيق الضعيف بين الفرض الديني والقناعة العقلية، أو القبول بالتناقض المفترض بينهما، وصولاً إلى تجاوز الفرض ضمناً أو صراحة.
والواقع إن هذه الإشكاليات قائمة على مغالطة القبول التلقائي بسلطة القراءة السلفية لحدود الثابت والمتحول، وذلك لصالح الأول وعلى حساب الآخر، في حين أن هذه السلطة مستحدثة، وقائمة لا على اعتبارات ذاتية داخلية للحجة المطروحة، بل على عوامل خارجة عنها، أهمها غياب الطرح البديل، نتيجة التحول الثقافي الذي شهده القرنان الماضيان والذي انضوى على اختبار سرديات جديدة لا تقتصر في استقاء مصادرها على الإطار الديني. نتيجة ذلك كانت تراجعاً ضمنياً عن المسؤولية عن الموروث النصي الديني لدى النخب التي كانت هذه المسؤولية مناطة بها قبلاً، ما أتاح المجال أمام التوسع السلفي في ادعاء ملكية النص وتفسيره. وقد حبذّت الظروف الاقتصادية، والتي منحت التوجهات السلفية زخماً ودعماً، انتشار القراءة السلفية بصفة المعيارية، وإن كانت غريبة عن معظم ديار انتشارها الجديدة. الإشارة إلى هذا العامل ليست للحصر بل للتنبيه إلى أن صعود القراءة السلفية لا يشكل دليلاً على تفوقها الموضوعي ولا على اقترابها الأوثق من الأصل، كما تدعي، بل هو حدث عرضي ناجم عن ظروف آنية مؤهلة أن تتبدل.
تبرز الحاجـة الى مواجهـة نقدية غير مبالية بالتهديد بالتكفير تتحدى صنمية التاريخ
والمسعى السلفي إلى توسيع نطاق الثابت يطال كافة العلوم والأمور كما العقائد، وينتقل في تحديد العديد منها من التقرير إلى الصنمية. فالقراءة السلفية لتاريخ صدر الإسلام على سبيل المثال، لا تكتفي بأن تضفي على هذا التاريخ بنية تنظيمية شاملة وصارمة، تصبح معها هذه المرحلة القدوة والأساس لصياغة أي نظام سياسي إسلامي والحكم على مشروعيته، ولكنها تجعل من الاختلاف في تقييم المرحلة، أو حتى في إبراز أوجهها المتعارضة مع القراءة التنميطية، فعلاً طاعناً لا في التاريخ والتأريخ وحسب، بل في الدين نفسه. فالإجماع القسري المتولد عن إغراق الثقافة الإسلامية بهذه المقولة هو أن حقبة الخلفاء الراشدين، على أقل تقدير، هي الحقبة المثلى في طبيعة النظام السياسي الإسلامي الذي يتوجب إعادة إحيائه وفرضه. وفي التعاطي مع حقبة الخلفاء الراشدين نموذج متكرر لمنحى الصنمية الذي يعاني منه الفكر السلفي. والصنمية هنا هي الانتقال من الرأي والاعتبار إلى التقرير الملزم، ومنه إلى القداسة، ومن القداسة إلى التكفير.
والقراءة الوقائعية، والتي تنطلق من مراجعة للموروث النصي تتجنب الأهوائية والعقدنة، هي أن حقبة الخلفاء الراشدين، والتي شهدت اغتيالات لثلاثة من الخلفاء الأربعة الذين توالوا عليها، كانت زمن فتوح واضطراب وبلبلة وتقاتل داخلي، ولم تشهد تطبيق نظام حاضر متكامل، بل توالد حلول آنية متآلفة حيناً متعارضة أحياناً. وهذه الحلول على اختلافها كانت تهدف طبعاً إلى إرساء الحكم المركزي، إلا أنها تبقى مرتبطة بالمرحلة التاريخية التي استولدتها إلى حد تنتفي معه إمكانية التعميم أو حتى القياس عليها. والجانب الأبرز في هذه الحلول، بطبيعة الحال، هو أنها كانت اجتهادات شخصية يتداخل فيها الرأي بالهوى، فأصابت في بعض الحالات وأخطأت في حالات أخرى وتسببت في أزمات البعض منها تفاقم ليؤدي إلى شروخ لا تزال قائمة إلى اليوم.
أما القراءة السلفية للحقبة عينها فتقلل من أهمية الاختلافات وتتعامل مع الحوادث بعد تنقيحها وتهذيبها على أنها جزء من كل شامل يستوجب التقليد. فإذا اختلفت وسائل اختيار الخليفة، فإن ذلك كان لتبيان الوسائل المشروعة المتاحة. وإذا اختلف الصحابة فيما بينهم، فإن ذلك كان في سعيهم إلى تبين معالم النظام المتكامل الذي جاء به الدين. ومهما اشتد خلافهم، فإنهم في نهاية المطاف قد بلغوا التوافق على استشفاف معالم هذا النظام وتطبيقه. وثمة معضلة هنا هي أن هذه التقارير اعتباطية، فوسائل اختيار الخلفاء كانت مرتجلة، ولم تأتي بناءاً على نص صريح أو توجيه مسبق، والخلافات بين الصحابة لم تفضّ بكاملها بل بقي العديد منها عالقاً.
غير أن القراءة السلفية تتجاهل هذه المعضلة وتعمد بدلاً من ذلك إلى تكريس شمولية الحقبة وفرضية الاقتداء بها من خلال إسقاط حديث ´خير القرون قرنيª عليها، محققاً لها القداسة التي تنقلها من إطار التاريخ الإنساني لترفعها إلى مقام المشروع الإلهي، فيغدو التحقيق النقدي لها خروجاً عن الدين أو تعدياً عليه. والنتيجة التلقائية لهذا الرفع هو أنه إذا كان ثمة فكر سياسي إسلامي، فلا بد لهذا الفكر أن يأتي مؤصلاً في هذه الحقبة دون غيرها. أي أن علم السياسة، ليبقى علماً شرعياً غير خارج عن الدين، من شأنه أن يقتصر وحسب على اعتبار ما انضوت عليه حقبة السلف الصالح هذه والقياس عليه لكل زمان ومكان، فيما الواقع أن محدودية تلك الحقبة زماناً ومكاناً وظروفاً تقف كعائق خطير أمام إمكانية تحقيق هذا الإلزام، فلا يكون تحقيقه إلا زعماً وادعاءاً.

مواضيع قد تهمك
والتجارب الإنسانية التي تطور على أساسها الفكر السياسي العالمي ضاربة في العمق التاريخي وغير مقتصرة على ثقافة أو حضارة. إلا أن هذه التجارب، بغضّ النظر عن أوجه تشابهها وصلاحيتها للمجتمعات الإسلامية، ترفضها القراءة السلفية، وترى أن الأمة الإسلامية في غنى عنها، إذ يكفيها الاقتداء بالسلف الصالح. وقد بالغت التوجهات السلفية في تشديدها على هذا الرأي وصولاً إلى اعتبار الأخذ بالفكر السياسي غير المؤصّل إسلامياً ضلالة أو شركاً أو كفراً صريحاً.
فالصنمية التي أسقطتها القراءة السلفية على التاريخ الإسلامي عامة، وعلى حقبة الخلفاء الراشدين خاصة، هي اليوم عائق هام لا أمام القراءة النقدية المستنيرة لهذا التاريخ وحسب، بل أيضاً أمام إمكانية الانتقال من المتابعة التاريخية إلى صياغة حلول سياسية تتناسب مع المجتمعات التي يشكل فيها المقوم المسلم الجانب الغالب اجتماعياً أو دينياً. وعليه، تبرز الحاجة إلى مواجهة نقدية غير مبالية بالتهديد بالتكفير تتحدى صنمية التاريخ، كما سائر الصنميات التي ابتدعها الفكر الإسلامي المسيّس في القرن المنصرم.
الصورة الرئيسية: الخليفة الأموي الوليد (674-715 م) كما تخيله رسام مستشرق مجهول