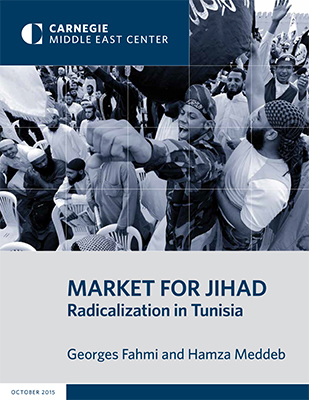نشر “مركز كارنيجي للشرق الأوسط” بتاريخ 16 أكتوبر 2015 دراسة بعنوان “سوق الجهاد: التطرف في تونس”، بقلم الباحثين جورج فهمي و حمزة المؤدّب. [1] شكلت تلك الدراسة مصدر اهتمام لي بوصفها تمثل دلالة بالغة على حالة التوهان وفقدان الاتجاه الصحيح، لدى مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار، في ما يتعلق بالتعامل مع واحدة من أخطر القضايا في تاريخ الإنسانية؛ وهي النمو غير المسبوق لظاهرة التطرف والإرهاب الإسلاموي التي غطى مداها كل خارطة العالم تقريباً.
بقلم: جمال عبد الرحيم عربي

في كلمات الشيخ محمد بن راشد: “داعش ليست منظمة إرهابية فقط، بل هي فكرة خبيثة. الأيديولوجيا التي قامت عليها داعش هي نفسها التي قامت عليها القاعدة وهي نفسها التي قامت عليها أخوات القاعدة في نيجيريا وباكستان وأفغانستان والصومال واليمن وفي بلاد المغرب العربي وفي بلاد الجزيرة العربية، وهي نفسها التي بدأت تضع بذورا لها في أوروبا وأميركا وغيرها من بلاد العالم (…) البنية العسكرية للتنظيم يمكن هزيمتها (…) ولكن ماذا عن البنية الفكرية لهذا التنظيم؟ (…) لا بد من مواجهة هذا الفكر الخبيث بفكر مستنير، منفتح، يقبل الآخر ويتعايش معه، فكر مستنير من ديننا الإسلامي الحنيف الصحيح الذي يدعو للسلام، ويحرم الدماء، ويحفظ الأعراض، ويعمر الأرض، ويوجه طاقات الإنسان لعمل الخير ولمساعدة أخيه الإنسان. إن الشباب الانتحاري الساعي للموت بسبب إيمانه بفكرة خبيثة لن يوقفه إلا فكرة أقوى منها ترشده لطريق الصواب”
وكما فهم الأمر الأمير سلمان بن حمد: “سينحسر مد هذه الجماعات و سيعود و لكن في غضون ذلك لا يجب أن نغفل عن محاربة و هزيمة الأيديولوجية التي يستندون عليها، إلى جانب ذلك يجب علينا التخلي عن مسمى (الحرب على الإرهاب) وتركيز جهودنا على مجابهة تصاعد هذه الثيوقراطيات الفاشية الآثمة”
ما تتبناه المؤسسات البحثية وصنع القرار السياسي كأسباب للتطرف الإسلاموي لا يعدو أكثر من أنها محفّزات
لقد تطرقت الدراسة لجانبين، أحدهما تحليل الوضع التونسي بغرض استكناه العوامل التي أدت للنمو المتواصل للتيار الجهادي التونسي، والآخر تقديم تصور للحل يتلخص في دعوة الحكومة التونسية وسائر الجهات السياسية والدينية الفاعلة في تونس إلى وضع استراتيجية لمواجهة التطّرف تؤدّي إلى إصلاح المجالين السياسي والديني. وفقاً للحيثيات التي تبنتها الدراسة، فإن تصاعد العنف في تونس وتصدير المتطرفين إلى سوريا والعراق وليبيا، يعود إلى عوامل شتى يأتي على رأسها احتكار الرئيس السابق بن علي المجال الديني وإهماله للقضايا الاجتماعية/الاقتصادية، خيبة أمل الشباب وسوء التعامل مع التيارات السلفية بعد الثورة، إضافة لاستمرار الركود وغياب الآفاق أمام الشباب وشعورهم بخيبة الأمل.
اقترحت الدراسة جملة من الحلول من ضمنها:
- إعطاء الأولوية لتعزيز الاندماج والترقي الاجتماعيَّين ومواجهة الإحباط في صفوف الشباب.
- توطيد الإدماج السياسي للحركة السلفية، مشيرة إلى أنه “ينبغي السماح للأفراد الراغبين في العمل ضمن الأطر السياسيّة المنظّمة والمجتمع المدني القيام بذلك بحرية في ظل احترام القوانين”.
- تحقيق التوازن في سيطرة الدولة على المجال الديني وسماح الدولة للقوى الدينية السلمية بالتعبير عن نفسها، وتشجيع الأئمة الرسميين على التنافس مع الدعاة السلفيين لإنشاء سوق أكثر تنوعاً للأفكار الدينية.
إنه، ومنذ بروز ظاهرة التطرف في العالم العربي والإسلامي، لم تخرج تحليلات مراكز الأبحاث المعروفة، في إطار تفسيرها للظاهرة وتناميها؛ لم تخرج عن أسباب محدودة، أصبحت محفوظة من كثرة ترديدها والدوران حولها. تتلخص تلك الأسباب في إحباط الشباب وانسداد الأفق أمامهم نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية، سيادة الطغيان وانعدام الديمقراطية، وأخيراً مساندة الغرب، خاصة أمريكا، لدولة إسرائيل وازدواج معاييرها عند التعامل مع القضايا العربية والإسلامية.
في اعتقادنا أن ما تتبناه المؤسسات البحثية ومراكز طبخ وصنع القرار السياسي كأسباب للتطرف الإسلاموي لا يعدو أكثر من أنها محفّزات، حيث أن الجذور الحقيقية إنما تكمن في مجال آخر وهو مجال الأفكار والمفاهيم التي تصيغ العقل الجمعي والوجدان الجمعي لشعوب العالمين العربي والإسلامي. وهذه خلاصة تؤكدها الآلاف من الأدلة والشواهد في الواقع؛ حيث من ضمنها:
- انتشار الأفكار المتطرفة في كل دول العالم الإسلامي ووسط الجاليات المسلمة في الغرب تقريباً، على الرغم من أن كثيراً منها يتمتع بدرجة عالية من الرفاه المادي، مثلما هو الحال في الخليج العربي والدول الغربية.
- انتشار تلك الأفكار أيضاً في دول بها قدر واسع من الديمقراطية كتونس وباكستان والكويت ونيجيريا والدول الغربية بطبيعة الحال.
- التدهور الاقتصادي والإحباط الناتج عن العطالة وقلّة الفرص المتاحة ظاهرة عالمية، عانت ولا تزال تعاني منها مجموعة كبيرة من دول العالم بدون أن تسفر عن تحول التطرف السياسي والفكري إلى ظاهرة مجتمعية كاسحة وواسعة النطاق، لدرجة تشكيلها معلماً لعصر كامل.
- لقد تعرض معظم العالم خارج أوروبا وأمريكا الشمالية للاستعمار والقهر، ومورست عليه انتهاكات وفظائع مهولة، بل إن هنالك شعباً تعرض لأحد أفظع المحن في تاريخ البشرية، وأشير هنا لضرب اليابان بالسلاح الذري وخضوعها المباشر للاحتلال الأمريكي، إلا أنها لم تؤد لنمو حركات غضب وتطرف وإرهاب يصل للحد الذي نشاهده الآن.
- انشغال الحركات المتطرفة بقضايا ليس لها علاقة مباشرة أو قريبة بالأسباب التي يوردها الباحثون، مثل سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو الأزمة الفلسطينية. بل من الواضح أن هذه الحركات تختار ساحات عملها في مناطق أبعد ما تكون عن تأثير مثل تلك الأوضاع؛ كاختيار داعش لمناطق بعيدة عن إسرائيل لممارسة عملياتها الرئيسية، أو اختيار المتطرفين أهدافاً لا علاقة مباشرة لها بالأسباب التي تحاول مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار إقناعنا بها، مثلما هو الحال في تفجيرات فرنسا وتفجيرات أميركا التي كان آخرها ببوسطون من قبل متطرفين شيشان لا علاقة لأمريكا بمشكلة بلادهم، وكذلك مسارح موسكو وقطارات لندن ومدريد والقتل المجاني الذي تمارسه بوكو حرام بنيجيريا، وتدمير مدارس البنات بباكستان وأفغانستان، وتفجيرات مصر وتركيا وكينيا واندونيسيا وتونس، واقتحام فنادق مومباي وباماكو، وقتل المصلين بمساجد السعودية، إلخ. بل إن التاريخ القريب يؤكد للناظر الحصيف أن تنظيمات الإرهاب كداعش والقاعدة لم يستهدفا إسرائيل بتاتاً رغم أنها الأقرب لنطاق عملياتهما، كما أن إسرائيل هي المسئول الأكبر عن قتل الفلسطينيين والمسلمين.
عطفاً على التقرير المشار إليه، نرى أنه لم يأت بجديد جوهري غير أنه ركّز على تونس تحديداً، وهو أمر يشكل في حد ذاته أحد إخفاقات السياسة الغربية؛ لأن ظاهرة التطرف الإسلامي ومقدرة التنظيمات الإرهابية على تعبئة الملايين معها، بل وتحييد أغلبية المسلمين الآخرين الذين لم تنجح في كسب تعاطفهم المباشر، إنما هي ظاهرة عالمية تغطّي كل أرجاء الكوكب تقريباً. لذا يصبح منطقياً، بل وواجباً، أن نبحث عن جذورها وأسباب نشوئها ومسارات تطورها، نبحث عن ذلك بشكل عام بقدر عمومية الظاهرة.
إن الحركة السلفية، لكونها أحد الروافد الرئيسية للتطرف؛ تكاد تكون هي الحركة الوحيدة التي تستمتع بأعلى درجة من الحرية في العالمين العربي والإسلامي
ربما يكون الجديد في التقرير المشار إليه أنه لم يستخدم الحجج المكررة الأخرى في تبرير البروز الطاغي للتطرف والإرهاب؛ كعزو التطرف والإرهاب لموقف الغرب من القضية الفلسطينية وازدواج معاييره تجاهها، والحجة الأخرى التي سادت أيضاً قبل الأحداث الأخيرة والقائلة بغلبة الدكتاتورية والطغيان في نظم الحكم العربية. يبدو من الواضح أن تجاهل هذين العاملين في متن الدراسة المشار إليها إنما كان بسبب الاكتشاف المتأخر لمراكز الأبحاث والتفكير في الغرب لعدم اهتمام المتطرفين بقضية فلسطين من الأساس حيث اختاروا للقيام بمجازرهم أبعد نقاط ممكنة عن إسرائيل، بل إن القضية الفلسطينية لا ترد حتى في أدبياتهم إلا لماماً! كما تبين للباحثين بالدليل العملي أن قضية الديكتاتورية والطغيان السياسي ليست هي العامل المحدد للتطرف بدليل ازدياد هذا التطرف في النموذج الناجح الوحيد تقريباً للديمقراطية الليبرالية في الوطن العربي وهو التجربة التونسية!

مواضيع قد تهمك
من الدلائل الواضحة على خطأ الفرضيات التي قام عليها التحليل أن بعض التوصيات نفسها أبعد ما تكون عن ملامسة الحل. فتوطيد الإدماج السياسي للحركة السلفية عبر “السماح للأفراد الراغبين في العمل ضمن الأطر السياسيّة المنظّمة والمجتمع المدني القيام بذلك بحرية في ظل احترام القوانين” لهو أمرٌ قائمٌ أصلاً. بل إن الحركة السلفية، لكونها أحد الروافد الرئيسية للتطرف؛ تكاد تكون هي الحركة الوحيدة التي تستمتع بأعلى درجة من الحرية في العالمين العربي والإسلامي. كما أن “السماح للقوى الدينية السلمية بالتعبير عن نفسها، وتشجيع الأئمة الرسميين على التنافس مع الدعاة السلفيين لإنشاء سوق أكثر تنوعاً للأفكار الدينية”، كلّ ذلك موجود ومتاح إلا أنه يأخذ شكل مسرح الرجل الواحد، حيث إن الأغلبية الساحقة للأئمة الرسميين الذين ينبغي أن ينافسوا الدعاة السلفيين هم أنفسهم دعاة سلفيون بشكل أو آخر. أما القلة من المعتدلين فعلاً فيفتقد اعتدالهم هذا رؤية مغايرة وسنداً فكرياً قوياً يقوم على أصول معرفية متمايزة عن تلك التي يستند عليها السلفيون، تلك الأصول التي تم إرساؤها من قبل مئات السنين، وأصبحت من البديهيات من فرط رسوخها واعتمادها من قبل المؤسسات الدينية الرسمية. كما أن هؤلاء المعتدلين، على محدوديتهم، يعانون الحصار الإعلامي والإداري الذي يقع عليهم من قبل المؤسسات الرسمية والمدنية التي يسيطر عليها السلفيون مما يجعل أصواتهم تذهب هباءً منثوراً.
أهمية تغيير المنحى الحالي للسياسة الغربية:
لقد أخطأ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة كثيراً في تحديد جذور وخصائص وأسباب ظهور الفكر الأصولي الثيوقراطي، ذلك الذي يضرب الآن في أركان العالم جميعا. وحتى الآن يغفل الغرب عن النظر للجانب الفكري والأيديولوجي في إنتاج هذا الإرهاب. إن الإطار الفكري الطاغي في المجتمعات الإسلامية الآن، إطار ثيوقراطي نكوصي بشكل عام لا يقبل الحياة والتعايش مع قيم الحداثة وإنما يتصالح مع إنجازاتها المادية فقط. إطار يريد حبس قيم المجتمعات ومفاهيمها ومؤسساتها السياسية والاجتماعية والقانونية في حدود ما كان عليه الأمر قبل 1000 عام، ويدّعي بأن حلول قضايا اليوم موجودة في تراث الماضي المغلق.
صحيح أن الأغلبية الساحقة من العرب والمسلمين يودون العيش في سلام وينشدون التفاعل مع العالم بإيجابية، لكن على ضوء الواقع فإن الإطار الفكري السائد الآن ضعيف لحد كبير في أداء دوره كمحفّز لتبني قيم الحداثة وتعزيز وجودها في العقل والوجدان الجمعي القائم، كما أنه لا يوفر الترياق المناسب لقطع وشائج التطرف والإرهاب بالمصادر الأساسية لذلك البناء الفكري والذي تأسست أصوله قبل مئات السنين. إن أيديولوجيا التطرف والإرهاب لم تنتج عن فراغ أو تنشأ خارج منظومة المفاهيم المؤسسة للثقافة العربية الإسلامية، لذا فإن القضاء عليها يستلزم، وبالضرورة، مراجعة تلك المفاهيم وربطها بقيم العصر كضمان لتجفيف المنابع الفكرية لأيديولوجية الحاضنة للتطرف والإرهاب، من جهة، وكقوة دافعة وخلاقة يمكن أن تلهم شعوب المنطقة لغذ السير نحو بذل المساهمة الفاعلة في التقدم الإنساني العام، من جهة أخرى.
الإرهاب فكرة وليس دولة:
لقد تبيّن من ردود أفعال قادة وساسة الغرب التي أعقبت أحداث فرنسا الدامية خلال شهر نوفمبر 2015، وعزمهم على محاربة وهزيمة تنظيم داعش عسكرياً، تبيّن بأن هنالك إهمال واضح لحقيقة أن داعش تمثل فكرة وليس كياناً جغرافياً أو تنظيماً سياسياً له معالم واضحة تُحرّك له الأساطيل بحراً وجوّاً. أبسط الدلائل على ما نقول إن داعش خلقت لها أرضاً ودولة بالمعنى الجيوسياسي في خلال فترة قصيرة جداً، وبواسطة حشد من الناس لا ينتمي إلى هذه الأرض أصلاً، مثلما حدث من شقيقتها القاعدة ومناصريها الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من إحكام قبضتهم على كامل جمهورية مالي، وبالتالي تغيير موازين القوى في شمال وغرب أفريقيا بشكل حاسم، لولا التدخل العسكري الفرنسي الحازم أوائل عام 2013. فالإرهاب، إذاً، قادر على التأثير على المسلم العادي وتحويله لقنبلة في وقت قصير جداً كما هو واضح من النماذج التي قدمها الإعلام عن الانتحاريين الذين كانوا إلى وقت قريب من مدمني الخمر أو المخدرات أو أصحاب السوابق الجنائية، كما أنه قادر على خلق دولة أو شبه دولة في وقت وجيز عندما تتوفر شروط بسيطة لذلك. عليه فإن اتجاه النظر يجب أن يتحول من التمعن في الأرض إلى التركيز على ما في الرؤوس!
الثابت أن هنالك مقولات تطرح بكثافة من قبل معظم الباحثين والسياسيين والنشطاء وتشير إلى أن هؤلاء المتطرفين قلة قليلة ولا يعبرون إلا عن قطاع صغير من المسلمين وبالتالي فإنه يجب ألا تحمل المجتمعات الإسلامية المسئولية عن شذوذ أمرهم. هذا حديث رغم صحته الظاهرة إلا أنه يخفي الحقيقة الأكثر أهمية وهي أن المسئولين عن التطرف والإرهاب ليسوا هم الناس الذين يكوّنون هذا المجتمع، وإنما المناخ الفكري الذي يسود في هذه المجتمعات والذي يدفع الشباب للسير في طريق التطرف والإرهاب. فالواقع أن أبرز سمات هذا المناخ، والتي نعتبرها أس المشكلة، اعتماد المجتمعات المسلمة على مفاهيم محددة للإسلام تم تبنيها على المستويات الرسمية والشعبية، مفاهيم لم يتم تجديد أصولها منذ ألف عام تقريباً. تلك المفاهيم ترسخ التصورات التالية في العقل الجمعي للمسلم المعاصر:
- حل كل قضايا الإنسان، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالعلم الطبيعي والاجتماعي، إنما هي جزء أصيل من منظومة الدين.
- المعيار الأساسي في تحديد الموقف من الظواهر الاجتماعية يتم من خلال مفهومي الحلال والحرام وليس الترجيح بواسطة العقل من خلال مفهومي الصواب والخطأ، أو الضار والنافع.
- العلاقة بين الإسلام والكفر به علاقة تناحرية.
تتمظهر وتتجلى هذه التصورات في النواحي العملية والسلوكية للإنسان المسلم بأشكال غاية في التنوع تبعاً للاختلافات في درجة الثقافة والمعرفة وطريقة التربية إضافة للمناخ الاجتماعي والسياسي. إن الفهم العام للأغلبية من المجتمع المسلم، وكذا سلوكها، يجنحان نحو التمسك بأداء الشعائر الدينية بشكل منتظم والأخذ بالقيم الدينية العامة كالفضيلة والصدق والبعد عن المحرّمات المعلومة كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وذلك ينم عن تصالح مع حقائق العصر وقيمه العامة. إلا أن هذا لا يلغي وجود أقلية مؤثرة عددياً وفكرياً تجنح للتشدد، منها ما يكتفي بالتشدد المحدود كالموقف المتخلف من المرأة والديمقراطية والتمسك بالشكليات كإطلاق اللحى وتقصير الثياب، ومنها ما يزيد تشدده ليوسّع دائرة المحرّمات لتشمل كل المنتجات الفكرية والنظام القيمي للمجتمعات المعاصرة، وأخرى تصل في عميق تشددها إلى درجة تفضيل الموت على الحياة لتطبيق رؤيتها للمجتمع الإسلامي المُتخيّل من ناحية، ولتخليص الذات من كل خطاياها وذنوبها السابقة، من ناحية أخرى.

مواضيع قد تهمك
للأسف، فإن المنحى الصاعد عددياً وفكرياً هو المنحى المتشدد بمختلف نكهاته. وهو أمر لا يحتاج لمجهود كبير لإثباته. يكفي أن نشير فقط إلى أنه وحتى الآن لم يوجد عمل شعبي في العالم الإسلامي، ولو محدود النطاق، يدين السلوك البربري للأقلية التي تزرع الإرهاب في كل العالم بما في ذلك المجتمعات السنية المتفقة مع المبادئ العامة للإسلام السلفي نفسه، كتفجيرات السعودية وتونس مثلاً. كما يكفي أن نعود لمَشَاهد الأيام الأولى للثورتين السورية والليبية في مرحلتيهما السلميتين لنرى أن الخطاب السياسي كان كله تقريباً قائماً على الدين في شكله السلفي. بل يكفي الاطلاع على ما يدور في وسائط التواصل الاجتماعي حيث الأغلبية الغالبة من المسلمين العاديين، تدين الإرهاب لكنها تبحث له عن تفسيرات خارج إطار ما تحمله هي من فكر كالقول إنه نجم عن قتل إسرائيل للفلسطينيين أو مذابح الفرنسيين ضد الجزائريين، وما إلى ذلك. كل ذلك بدون أن يكلف أحدهم توضيح الأسباب التي صرفت اليهود من استخدام النهج الانتحاري ضد ألمانيا رغم أن ما ارتكبته الدولة النازية حينذاك (الداعم الأكثر أهمية للاجئين المسلمين اليوم) من مجازر تجاههم أفظع بما لا يقاس بما يحدث للفلسطينيين، ولماذا لم يتّجه اليابانيون ذات الاتجاه وهم الذين تعرّضوا لأبشع محنة عسكرية عندما قضي على مئات الألوف منهم بفظاعة لم تشهدها البشرية في تاريخها؟، ولماذا لم تؤد حرب فيتنام الظالمة إلى انتقام الشعب الفيتنامي من أبرياء أمريكا بأن يفجّر طائراتهم مثلا؟، ولماذا تتعايش دول شرق أوروبا بشكل سلمي مع الأتراك الذين أذلوا الأرمن والبلغار لسنين طويلة، ومع الروس الذين مارسوا عليهم قهراً عظيماً وعطّلوا تطورهم الاقتصادي والسياسي لعشرات السنوات، والأمثلة أكثر من أن تحصى في الواقع؟.
وإذ نستقرئ الوضع الحالي وارتباطه الوثيق بأصول فكرية مستندة على تفسير معين للدين، وضعت لبناتها قبل ما يقرب ألف عام، فلا بد من التأكيد بأن التشدد والتطرف الذي يمكن أن يصل مرحلة استواء الموت والحياة ليس شيئاً جديداً في تاريخ العالم الإسلامي. بل يمكن القول أن بذوره قد غرست في قلب المكوّن الفكري والثقافي للدولة العربية الإسلامية منذ بدايتها. إنه، وكأمثلة قريبة في التاريخ يمكن الإستشهاد بتجربة انتصار الوهابية بالجزيرة العربية في القرن الثامن عشر وتجربة الثورة المهدية بالسودان في القرن التاسع عشر، اللتين لم تكونا أقل عنفاً و بشاعة وميلاً لإهدار الدماء عما تفعله داعش الآن، بما في ذلك النظر لكل العالم باعتباره دار كفر وجب قتاله حتى يركع ويدخل عنوة دار الإسلام.
ما العمل؟
من الواضح أن المجتمع الدولي بأسره يخوض معركته الحالية مع الإرهاب بوسائل عسكرية وأمنية تقليدية مع الاستعانة بالسياسة في بعض الأحيان، وهو أمر يمكن القبول به في حالة الصراعات العسكرية التي تقوم بين الدول أو بين دولة ومتمرديها حيث إن العقائد السياسية والأمنية مبنية أصلاً على حماية الوطن وضمان وحدة أراضيه.
لا بد أن يستهدف الضغط السياسي إرجاع المسجد لوضعه الطبيعي كمكان للعبادة وليس للسياسة وتعبئة المشاعر وبث الكراهية
إن المعركة مع الإرهاب مختلفة جداً. فالعدو لا تربطه صلة مباشرة بالأرض التي يقاتل على ظهرها، وليس حريصاً عليها كثيراً حيث إن مفهوم الوطنية غير موجود عنده أصلاً. أيضاً العدو غير ثابت العنوان أو الهوية الشخصية. يمكن أن يظهر في أي مكان في العالم ويمكن أن يوجه ضربته لأي موقع ثابت أو متحرك. كل ما يحتاجه ذلك العدو هو القليل من المتفجرات والبسيط من الأسلحة. وكما وضح من أحداث فرنسا في المرتين، فالعدو لم يتعد أصابع اليدين من ناحية العدد، لكنه في دقائق حبس أنفاس كل العالم وغيّر مؤشرات السياسة والاقتصاد وتحركت بموجبه أساطيل وألوف من قوات النخبة في أفضل جيوش العالم.
المعركة مع الإرهاب والتطرف الإسلاموي معركة استراتيجية. تحتاج من المجتمع الدولي والإقليمي لمعرفة صحيحة لميكانزيم نشوء وتطور هذه الجماعات، وقبل ذلك الاقتناع بأنها قضية أيديولوجية في المقام الأول. فإذا توفر هذا الشرط، يمكن للمجتمع الدولي التغلب عليها في أقصر وقت ممكن وبأقل آلام ممكنة. وذلك ممكن، من وجهة نظرنا، عبر المحاور الإضافية التالية باعتبار أن المحور العسكري الأمني هو المحور الفاعل حالياً:
المحور الفكري
لقد سبق وأشرنا إلى أن الخطاب الإسلامي، ولا نقول الدين الإسلامي، السائد حالياً تمت صياغته منذ ما يقارب الألف عام. وهو المسئول، على مستوى مبادئه المؤسسة التي تقوم على تغليب الرواية على الدراية أو النقل على العقل، عن الظواهر السالبة في العالم الإسلامي اليوم، من فقدان للحكم الرشيد، مروراً بالإسهام الضعيف في كل مناحي الحضارة الإنسانية، إنتهاءاً بالعمل على تدمير هذه الحضارة ذاتها. من شاكلة هذه المبادئ المؤسِّسة مفاهيم: “لا اجتهاد مع النص”، “العبرة بعمومية الأصل وليس خصوصية السبب”، “إجماع الجمهور” و ما إلى ذلك من آراء ومفاهيم ليس لها علاقة بالدين بقدر ما هي أفكار علماء وفقهاء القرون الماضية جرى تثبيتها باعتبارها جزءاً من الدين نفسه، رغم أن القرآن قد حرّم بوضوح إعطاء أي اعتبار لغير كلام الله: “اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون – الأعراف”، ورغم أن في تجربة الخلفاء الراشدين من الأمثلة ما يؤكد أن مفهوم “لا اجتهاد مع النص” الذي تمّ إغلاق العقل الجمعي المسلم بسببه، غير صحيح.
لحسن الحظ أنه قد شهدت العقود الأخيرة بروز مئات الأصوات الشجاعة، التي تولّت أمر مراجعة التراث العربي الإسلامي ونقده باستخدام أدواته نفسها، والأهم من ذلك أنها وضعت أسس خطاب إسلامي جديد له المقدرة على خلق التوافق والتوازن المطلوب بين مقتضيات الدين ومتطلبات العصر. لقد أصبح متاحاً ولأول مرة في التاريخ الإسلامي القريب أن تتوفر إمكانية حقيقية لدحض المدرسة السلفية باستخدام النص الديني نفسه. ولحسن الحظ أيضاً أن بعض القيادات السياسية في الشرق الأوسط، والتي لا يمكن التشكيك في ولائها الديني، وضعت أصبعها على مكمن الألم نفسه، مثالاً على ذلك ما صدّرنا به هذه المقالة من أقوال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية، حاكم دبي، والأمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين.
يغفل الغرب عن النظر للجانب الفكري والأيديولوجي في إنتاج هذا الإرهاب
وعندما نقول إن الأساس الفكري للتطرف والإرهاب قد قوّض أو هُزم، فإنما نعني أن ذلك قد تم على مستوى النظرية، وبالطبع لا قيمة لأي نظرية إلا في ارتباطها بالواقع. يصبح من الحتمي، طالما توفّر الفكر البديل، أن تكون هنالك إرادة سياسية لتعطيه المشروعية في الانتشار والنمو كما يجب أن تتاح له المنابر والقنوات ليحقق التأثير المُبتَغى.
المحور السياسي
إن الفكر السلفي هو المسئول المباشر عن التطرف باعتبار أنه المزود للتيار الجهادي بالأفكار المؤسِّسة التي تطرقنا لها سابقاً والتي يمكن تطويعها بسهولة لتخدم أهداف التطرف والإرهاب. هذا الفكر، السلفي، هو الفكر الإسلامي الوحيد الطليق السراح في الدول الإسلامية، والوحيد الذي يجري تلقينه للناشئة والكبار، والوحيد المسموح له بالتعبير من خلال منابر المساجد. والحال كذلك، لابد من الضغط السياسي الكثيف لتهيئة المناخ المناسب لنشر فكر ديني بديل يستند على الرسالة نفسها، ويتلاءم مع العصر، ويتفق مع القيم الإنسانية العامة التي توصلت إليها الإنسانية والتي قبلت بها منظومة الدول الإسلامية في غالبيتها.
هذا الضغط السياسي المقصود لا بد أن يستهدف إجبار تلك الدول على السيطرة الفاعلة على تلك المؤسسات الدينية ذات الإمكانات المادية الهائلة في اتجاه الحد من تأثيرها السالب من جهة، وإفساح المجال لأصوات الاستنارة والعقلانية من جهة أخرى. لقد كان من المذهل حقاً أن تتولى الدولة المصرية، وهي تعاني ما تعاني من ضربات الإرهاب، تتولى خنق أحد الأصوات المحدودة التي تتصدى للفكر السلفي من داخل الدين نفسه، والتي وجدت لها منفذاً تلفزيونياً كالسيد/ إسلام بحيري. لقد جرى قهره بشكل مؤسسي من أجهزة الدولة وإبعاده عن الإعلام بشكل يدعو للدهشة بل وللرثاء. في ذات الوقت، تفتح نفس الدولة التي تحارب الإرهاب، أبواب الإعلام الرسمي وغير الرسمي لآلاف الأصوات المعبّرة عن الفكر السلفي الذي يغذي التطرف والإرهاب الذي يحارب ذات الدولة!

مواضيع قد تهمك
لا بد أن يستهدف الضغط السياسي إرجاع المسجد لوضعه الطبيعي كمكان للعبادة وليس للسياسة وتعبئة المشاعر وبث الكراهية. فالمسجد اليوم يلعب دوراً سلبياً خطيراً للغاية في نشر الخطاب السياسي كما يمثل ملتقىً حراً لدعاة الفكر السلفي للاستماع لتعليمات الدعاة وتنظيم نشاطاتهم. وفي هذا نرى أن نماذج الجهاديين الأوروبيين تقدم دليلاً حياً على خطورة المساجد في تهيئة المناخ الملائم لنمو التطرف والإرهاب حيث وضح أن الأغلبية العظمى منهم تشكلت قناعاتهم عبر استخدام المساجد بشكل أو آخر.
إضافة لذلك لابد للضغط السياسي المنشود أن يستهدف إصلاح العملية التعليمية في اتجاه الإعلاء من شأن العقل، وتعظيم القدرات التحليلية للطلاب بديلاً عن أساليب التلقين والشحن البالية. إن النظام التعليمي في الدول الإسلامية مبني على تدريس المواد الدينية بشكل إجباري ومكثّف منذ مرحلة التعليم قبل المدرسي وحتى مرحلة الدراسة الجامعية؛ ومعلوم أن هذه المقررات التعليمية قد تم وضعها من ذات المؤسسات التي تتبنى الفهم السلفي للدين، عليه لا بد من ممارسة ضغط سياسي مواظب في اتجاه تخفيف الجرعات الدينية القائمة على التلقين في العملية التعليمية لتتناسب مع قدرات الطلاب الذهنية والنفسية، إضافة لتنقية مقررات التربية الدينية من جميع ما يمكن أن يساهم في تشكيل ذهن الطالب بشكل تجعله معادياً لقيم الحداثة ومناهج تحقيقها.
المحور الإعلامي
من سخريات القدر، أن تتحول أعظم إنجازات الإنسان المعاصر كالبث التلفزيوني المباشر والشبكة العنكبوتية لأهم وأخطر سلاح في يد التطرف والإرهاب. إنه وبنظرة عابرة إلى محتوى قنوات البث في العالم الإسلامي نجد الأغلبية الساحقة منها منصة لنشر الفكر السلفي بمختلف نكهاته، ومسرحاً لبث دعوات التخلف الفردي والاجتماعي. بذات القدر، فإن الأغلبية الساحقة من المواد المتداولة عبر وسائط التواصل الاجتماعي الإلكترونية مكرسة في ذات الاتجاه. مئات الرسائل الجديدة يجري إطلاقها يومياً لتحاصر الإنسان المسلم بمواد مكتوبة ومسموعة ومُشاهَدة مقتطعة من كتب التراث الديني العتيقة وندوات “العلماء” والفقهاء، بشكل لا يعطي الفرد المسلم الفرصة ليفكر بشكل عقلاني مستقل. إنه من الواضح جداً من خلال الرصد والتحليل، أن تلك المواد المبثوثة يجري إعدادها بدرجة عالية من الاحترافية حيث يتم عرض الأحداث الصغيرة التي يمكن الاستفادة منها لتوصيل رسالة ما مثلاً، بشكل مضخم وبزوايا مختلفة حتى تعطي المفعول المطلوب منها.
كمثال على ما نقول، فإنه قد تم، بالتلازم مع اعتداءات فرنسا الأخيرة، بث عشرات المقاطع التي تركّز على فظائع الحرب الفرنسية في الجزائر وإبرازها بطريقة يقصد منها إطفاء أي تعاطف مع ضحايا اعتداءات فرنسا باعتبار أنها رد فعل طبيعي ومشروع، بينما يتم الصمت تماماً في حالة التفجيرات التي تطال المسلمين الذين ينتسبون لذات المذهب الديني كتفجير المساجد بالسعودية أو الحافلات بتونس. لقد بلغ من سيطرة المحتوى السلفي وانطلاق يده، درجة أن وسائط الإعلام والتواصل أصبح أحد شواغلها المهمة مسائل الإعجاز العلمي حيث تصبح اكتشافات الإنسان المعاصر معجزة إلهية تم الإشارة لها في القرآن الكريم من قبل 1400 عام في منافاة تامّة للتفكير الطبيعي السوي! إن خطورة هذا المحتوى ليس في كون أنه مضلل فحسب، وإنما في تكريسه لفكرة خطيرة، عبر الطرق المتواصل الذي لا يهدأ لحظة، بأن حل كل قضايا الإنسانية موجود في الدين. ومن المعلوم بداهة لدى العامة أن الدين يفسّره ويقدّمه المتخصصين فيه من الأئمة والدعاة و “العلماء”.
لذا يصبح لزاماً، على أي قوى تستهدف محاربة التطرف والإرهاب، أن تضع في اعتبارها وضع قوانين صارمة، كيفما وأينما كان ذلك متاحاً، لإغلاق هذه المنافذ التي يتسلل عبرها الفكر المتطرف. وفي ذات الوقت لا بد أن تنشأ مؤسسات إعلامية بقدرات كبيرة ليتم عبرها دحض الأفكار الأساسية التي يقوم عليها الفكر السلفي، وبث الفكر الإستناري البديل.
[1] http://carnegie-mec.org/2015/10/15/market-for-jihad-radicalization-in-tunisia/ij5l